Kurd Day
Kurd Day Team
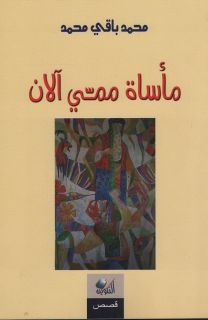
مأساة ممّي آلان
قصص قصيرة
محمد باقي محمد
الإهداء..
" أغامر بتفسير؛ الكتابة هي
الملاذ الأخير لمـن خـان "
ــ جان جينيه ــ
" ليست وظيفة الكتابة أو نتاجها
طمس جرحٍ أو علاجه، وإنما
إعطاؤه معنىً وقيمةً، وجعله
في النهاية لا يُنسى "
ــ آني إرنو ــ
هواجس شــخصية
بــداية النهـاية :
إذن فهي النهاية يا حسن! وها أنت تقف في حضرة الموت عجوزاً متداعياً و سقيماً، فيا لها من نهاية! سبعون عاماً! سبعون عاماً تشكّل خطاً مستقيماً بين قطبي الولادة والموت، وعلى حواف هذا الخط تناثرت الرغبات والأحلام المنكسرات، فيما تناهبت الخط نفسه الهواجس والأحزان الصغيرة، سبعون عاماً من الإقدام الإحجام، من الاندفاع والانتظار والترقب! وها أنتذا بعد سبعين عاماً تفاجأ بأكثر الحقائق ثباتاً في حياتك..
الموت!
ردح مديد من الزمن ليكتشف المرء ـ في آخر المطاف ـ أنّ النصر ترب الهزيمة في معركة كهذه!
أية حماقة يا رجل، وأية عذابات!؟ فأنْ تحمل صليبك من سـورية إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى العراق، إلى إيران، لتعود في النهاية إلى سورية، من غير أن تنسى المرور بتركيا، حماقة ما بعدها حماقة! وإلاّ فما الاسم الذي تقترحه لمعركة تستمرّ سـبعين عاماً في سبيل رغيف من الخبز، وينأى!؟ أن تشتدّ قامتك للنهوض مع بداية قرن، وهاهي تكاد تناطح نهايته، ثّم ربي كما خلقتني!
حسناً! بمَ تجيب السائل عن هذه الرحلة!؟
أتقول؛ في واحدة من لحظات الغفلة تكاثر الأولاد، وانفتح عليك ألف باب!
رباه! وأي أولاد!؟ في الدراسة وما أفلحوا، ولم يثبت أحدٌ منهم في عمل أكثر من أشهر معدودات، وحين انكسرت فقرات العمر، وألجأتك الحاجة إليهم، ما وجـدت فيهم معيناً! حتى الوحيد الذي نجح في الدراسة، حمل شهادته، ومضى بعيداً! بينما لم توفّر ـ أنت ـ عملاً من أجلهم! فكم مرّةٍ خاطرتَ فيها بحياتك أيام (العصمنلي ) مع تبغٍ مُهرّب! وكم تحمّلتَ برود الإنكليز وجشع اليهود عتالاً في حيفا! وكم مرّ بك عرب وعجم لتخدمهم في فنادق حلب ودمشق وبيروت! وكم فجرٍ نديّ آنَسَك على الدروب (حوّاجاً) وضيعاً! ثمّ لا تسلْ عن مسح الأحذية في بيروت وبغداد ودمشق! و .. أوه … ماذا تتذكّر لتتذكّر!
أم تقول؛ خذلني زمني!
وهل انتصر أحد على الزمن!؟
حتى الذين خالوا أنّهم انتصروا، اكتشفوا ـ في النهاية ـ بأنهم واهمون!
وتردف بمرارة :
هاتوا دلّوني في أي جذرٍ النخر يكمن!؟
وسيقول لك البعض :
هكذا كُتب عليك وقُدّر!
وسيقول لك آخرون :
أخذتَ الأمور بجدّ فأخذتك بهزلٍ!
أخذتها بجدّ فأعطتك فرطاً في التوتر الشرياني، وتضخماً في القلب، والتهاباً في البروستات، وقصوراً في الكليتين، وارتفاعاً في نسبة السكر و " الكوليسترول"، وقرحة في المعي الغليظ، وأولاداً كثراً، وخلافه! وأخيراً، هاهي النهاية تأزف، وزهد الشيخوخة التي تستعدّ للموت يحلّ، ولا أحد! الأصدقاء تفرّقوا ـ فرادى ـ على مراحل! الذين كانوا يحيّونك امتنعوا عن التحية، والذين التقوا على مائدتك مراراً يجدونك اليوم مُبذّراً، كلّ نقائصك تجلّتْ للعيون اليواقظ المفترسة، وأكثرهم بلاهة كان يتنبأ لك بهذه النهاية، فلقد أفلستَ، وآنَ للجحود النافذ الصبر أن ينكأ الجراح! ثمّ إذا كان أولادك الذين تحدّروا من صلبك يتصرفون على هذا النحو، فما الذي تتوقعه من الآخرين!؟
أيّ فوات!؟
أن يخسر المرء معركة فلا بأس، ولكن أن يخسر حياة كاملة، ولا يشعر بتلك الخسارة إلاّ بعد فوات الأوان، فتلك مصيبة! والآن! لمن تترك هذه الزوجة التي رافقتك زمناً يربو على نصف قرن!؟ هذه الصابرة التي جاعت كي يشبع الأولاد، وعرت كي يلبسوا، وسهرت كي يناموا! أي صمتٍ سيرين على غرفتها!؟ وأية لقمة مغموسة بالذل والهوان تنتظرها فيما أنت عاجز وأعزل!؟
انكسار الحلم :
أية حياة هذه التي نحياها! ؟
طفولة موسومة بالنقص والحرمان!
وشباب مُترنّح بين مقاعد الدراسة الباردة، وقصور الأهل الأبديّ وفرص العمل النادرة، فهل هذه حياة! ؟
ثمّ ـ يا أخي ـ ماذا ترك لنا أهلونا! ؟
وحيدين تركونا في هذا التيه القاتم والعدواني المُسمّى مدينة، حيث كلّ فرد يحمل مُؤشره الخاص، ولا أحد يشعر بمن حوله، أو يدري من أين تأتي الأشياء، وإلى أين تذهب! وها سنوات العمر تتبدّد من غير مُنفرَج، فيما لم يورثني أبي من الدار وقطعة الأرض الصغيرة إلاّ فراشاً ولحافاً!
لماذا! ! ! ؟؟
لقد أكملتَ دراستك ـ قالوا ـ ولستَ بحاجة إلى شيء سواها! طبعاً أنا كنت أستطيع أن أطعن في وصيّته، بيد أنّ الموضوع كلّه ليس بذي جدوى!
ولكن هل تظنّ بأنّ أشـقائي كانوا عوناً لأمهم بقية أيامها!؟ حتى شقيقي الأصغر الذي انتقل للعيش معها، عاملها بدءاً بالحسنى، لكنّ عيوبها تكشّفتْ دفعة واحدة لزوجتـه، مع آخر قرش نهباه منها! فهل حرّكَ البقيـة ساكناً!؟ واليوم! هاهي العيون المعاتبة تطالعني بالسؤال..
لِمَ لا تحضر أمّك لتعيش معك!؟
حسناً! أليس من حقّي أن أتساءل، بأي منطق يطالبونني بذلك!؟ بمنطق أنّني درست، وأنّ أشـقائي لم يفعلوا!؟ اللعنة! لقد سرقت هذه الدراسة خمساً وعشرين سنة من عمري، بينما استولت خدمة العلم على ثلاث سـنوات أخرى! وها أنا بعد ثمانية و عشرين عاماً لا أملك من هذه الدنيا شيئاً خَلا هذا الراتب الذي يكاد لا ينهض بأعباء الأيام العشرة الأولى من الشهر!
فمتى يكون لي بيت مثلاً!؟
ومتى أتزوّج مثل بقية الناس!؟
أنت تعلم بأنّ أية فتاة ـ في هذه المدينة ـ لا تقبل بأقلّ من طبيب زوجاً، أو مهندس، ولا تسل عن أحلامها في بيت كامل الأثاث، وسيارة! فماذا نملك نحن من هذا كلّه!؟ ما الذي لنا في هذه المدينة الملعونة غير الحسرة والأحلام التي لا تجد لنفسها سنداً في الواقع!؟ كتباً! أشعاراً! أمسيات من الثرثرة حول الوطن والثورة والثقافة والتجارة، لنكتشف في النهاية أننا حالمون! مهزومون من قبل أن نبدأ! وأن حياتنا مُختزلَة إلى مُجرّد انتظار للإخفاقات المتكررة!؟
يا للأهل الذين أمضوا حياتهم في التراب! في التراب وُلدوا! وفي التراب عاشوا حياتهم، وقضوا في التراب، من غير أن يتفكّروا ـ يوماً ـ في مستقبل الأبناء الذين أنجبوهم! فإذا داهمهم الكبر من قبل أن يحسبوا له حساباً، أنشأوا يذكرونك بما صرفوه في تربيتك من عرق ودموع ونقود! متناسين بأنّهم هم الذين أنجبوك!
ثمّ أنّ المشكلة ـ أساساً ـ تكمن في المسافة بيني وبين أمي، في الطريقة التي ينظر كلّ واحد منّا بها إلى الأمور، وهي ـ في وهمي ـ مسافة غير قابلة للتخطّي! فأنا أحاول أن أقتنص من هذه الحياة الملعونة ما يتاح لي من لحظات، كأن أسافر قليلاً، أو أقرأ شيئاً من الشعر، وقد يعنّ في البال قدح من الخمر، فتكفهرّ الأجواء بيننا، وتظلّ تذكّرني بالحلال والحرام! وربما زارتني صديقة، لكن أمي امرأة مُتزمّتة، تشكّل عبئاً على حركتي! كنت أتمنى أن تكون المشكلة (محض) مادية، إذن لكنت أسهمت مع أشقائي في مصروفها، على ما يُشكّله هذا الإسهام لي من عنت، إلا أن هذه الأمنية ـ كغيرها من أمنياتي ـ لن تتحقّق!
الشاهدة :
هل هانت عليك العشـرة يا حسن حتى تركتني هكـذا وحيدة و مهجورة!؟ ولمن!؟ الأولاد وتفرقّوا من قبل وفاتك! ليتهم ـ فقط ـ حضروا جنازتك! ليتهم اجتمعوا من حولي مُعلنين ـ ولو كذباً ـ أنْ لا شيء في حياتي سيتبدّل بعد موتك! أو تساءلوا عنّي بين الفينة والفينة!
فهل كان ثمّة تقصير منّي في تربيتهم!؟
أما حملتهم على صدري أطفالاً صغاراً! ؟
أما سهرت الليـالي الطويلة بجانب أسرّتهم، أسقيهم الدواء، وأغطيهم إن تكشفّوا كي لا يطالهم البرد!؟
إذن! فهل لك أن تفسّرَ لي صمت ابننا الأصغر حيال تذمّر زوجته من عيوبي! أنت تذكر ولا شكّ أنّ ابننا ـ هذا ـ تأخّر في المشي، وأنّني بذلت في العناية به أضعاف ما بذلته لأشقائه! ولو أنّ الأمر اقتصر عليه لهانَ! طبعاً أنت لن تصدّق بأنّ ابنتنا الكبرى اعتذرت عن عيادتي مُتذرّعة بأطفالها وزوجها، بينما ادّعت الصغرى بأنّها مريضة أكثر منّي، وأنّها تحتاج إلى من يعتني بها، فكيف لها أن تعتني بالآخرين! تصّورْ! الآن فقط أصبحنا آخرين!
قالوا .. القسوة من سمات الذكورة!
ولكن ماذا عن البنات!؟
قالوا.. لا بأس!
ولم نكن نملك إلاّ أن نهزّ رؤوسنا بأسى!
وقالوا .. إنّهم جهلة، فماذا نقول لهم!؟
ولكن هل كناّ نفكّ الحرف يوماً!؟ ثم هل اختلفت الحال مع المتعلّم فيهم!؟ ستكذّبني إن قلت لك، بأنّه يتهمنا بالجهل والتخلف! ويدّعي بأنّنا لم نكن نفكّر فيهم، ولم نترك لهم شيئاً يواجهون به العالم! فهل كان علينا أن نلتفت إلى أنفسنا حتى ننفي عناّ صفة التخلف!؟ لقد ضحّينا في سبيله بلقمتنا، فكيف نسي ليالي الشتاء التي كان يفاجئنا فيها، ليمتصّ ما في جيوبنا من نقود، ويسافر في صبيحة اليوم التالي، فإذا طلبنا إليه البقاء يوماً أو بعض يوم كي نشبعَ من رؤيته، احتجّ بدروسه!؟
إنّه يشعر بالعار من انتمائه إلينا يا حسن! فهل ثمة ما هو أقسى من شعور كهذا!؟ أهناك ما يجبره على الإقامة في المدينة، في حين أنّه يُعلمّ في قريته!؟ أنت لن تصدقني إذا قلت لك بأنّه يضنّ عليّ بلحظات يزورني فيها بعد دوامه!
ولكن بالله عليك لماذا لا ترد عليّ!؟ أنت لم تُفاجأ كلياً بما أنبأتك به، أليس كذلك!؟ إنّهم أولادك، وأنت تعرفهم جيداً، فإذا تفكّرت قليلاً أمكنك التنبّؤ بشيء من هـذا القبيل! ربّما تساءلتَ مُستنكراً؛ أإلى هذه الدرجة!؟
إذن ماذا لو خبّرتك عن البرد الذي ينخر عظامي ويفتّتها!؟ ماذا لو كلمتك عن الصمت الذي يجلّل أيامي بالوحشة!؟ ماذا لو حدّثتك عن الوحدة التي ترين على لياليّ الطويلة، وتشيع فيها المرارة والخواء! ؟
ولكن أيّ جدوى!؟ فلقد فاتَ الأوان! نعم، فاتَ!
مأساة ممّي آلان
الليلة الأولى :
أنّ الراوي قال :
فلما نأى ذلك اليوم البعيد ـ الذي قـاد فيه العسكر " ممّي آلان " إلى " السفر برلك " ـ عن الذاكرة الواهنة لأمٍّ أضناها الفراق، جفاها النوم، وهجرتها الطمأنينة، وعلى قلبها والعينين ران تأرّق عنيد، فخرجت إلى صحن الدار تناجي طيف وحيدها الغائب ..
أيتها الذرى الذاهبة ـ بعيداً ـ في السماء، أيْنهُ!؟
لا تهزي أكتافك المُتدثرة بالخضرة، لتقولي لي ـ من ثمّ ـ بأنّك لا تعرفين! فلقد خالسَني يوماً، وانحدر نحو أقدامك على صهوة جواده الكميت!
أيتها الشعاب والغيران الغائصة في ضباب الصباح، بالله عليك دلّيني، أين أخفيتِ " ممّ "، ولا تنكري على أمٍّ مُلوّعة سندها الوحيد وفلذة كبدها!
أيتها اللغة التي تفيء إلى الصمت، ألستِ شاهدة على أنك كنت قد أعرته أجنحتك الشفيفه لحظة أن رحل، فإذا تغافلتِ عن توسّطك في ما بيننا آنئذ، فلا تذهبي إلى أنك ما كنت الكلمات الغميسة بالأسى، حين قال.. ولكنني سأعود يا أماه!
وأنت أيّها " السفر برلك "! أما أزف أوان أوبته!؟ لكم أنت كتوم أيها " السفر برلك" كليل داج! لكم أنت مُؤلم مثلما خراج ـ في الجوف ـ ينـزّ!
آه أيّها " السفر برلك"! هي الشـيخوخة تخلخل العمر، مُبعثرة سنواته المُثقلة بلوعة الانتظار، وتبحث عن يدٍ حانية تفيض بين أصابعها الروح!
مقدّمات الليلة الأولى :
وقال الراوي :
وكانت الأم تجهل بأنّ " ممّوها " قد عاد، غبّ أن دخل الليل نصفه الأكثر صمتاً، وأسبلت المساكن جفونها!
أمّا لِمَ لمْ يسعَ (ممّ) إلى أمّه أوّلاً!؟
وما الذي دفعه لأن يتسلل إلى الدار من الباب الخلفيّ، ويندسّ في فراش زوجته ؟!
هل كانت الزوجة تعرف بأنّ حماتها جالسة في صحن الدار، تناجي صورة ابنها الغائب! ؟
أم أنّ " ممّ " كان يدفع الأقدار حتى ترتسمَ بالطريقة التي اتفّق وقوعها بها!؟
فإنّ الراوي لم يكن يملك إجابات شافية لهذه الأسئلة، لذلك فإنّه تجاهلها، وعاد يسهب في الكلام عمّا يعرفه، مردفاً :
وكان به شوق عارم لرؤية والدته وزوجته، لكنّه آثر أن يؤجّل لقاء أمه إشفاقاً على عمرها، فهل كان " ممّ " يعرف أنّه بذلك يحرف ليلته الأولى ـ هذه ـ عن مسارها، لتتّخذَ سمتها باتجاه أن تكون ليلته الأخيرة!؟
تفاصيل الليلة الأولى :
أمّا الزوجة، فتقول في معرض ما وقع من تفاصيل في الليلة الأخيرة :
ما إن دخل " ممّ " عليّ، حتى شعرت بأن ليلاً غامراً ـ ظلّ يضغظ بثقله المُبهظ على الأعماق لسنوات سبع ـ ينـزاح عنها، وأنّ غصناً ـ كنتُ قد توهّمتُ بأنّه يبسَ ـ شرع يُزهر فيها!
الليالي الطويلات المُتقلّبة بين قطبي القلق المُمضّ والحنين، تراجعت إلى حجمها وزمنها الموضوعيّيْن!
والجسد الذي ثار على الفوات والخسران آناء الليل وأطراف النهار هدأ واستكنّ!
والأشواق التي بثثتها له مع خفقات الأجنحة والرسائل، اجتمعت إلى بعضها جذلى، حتى لكأنّها كانت ـ حقاً ـ السبب في عودته!
شيئاً فشيئاً، كانت المُفاجأة المذهلة تلج سياقها، ومعها كانت الألسنة التي رمتني بالسوء في غيابه، والمحاولات التي رامت زعزعة علاقتي به ترتدّ إلى أصحابها مدحورةً!
قمتُ!
إلى أين!؟ قال، فقلت :
أزفّ البشرى إلى أمّك!
لكنّه قال :
هي امرأة طاعنة في السنّ، فدعي البشرى إلى أن يستيقظ الصباح!
زهرة دانية للقطوف كنت، وكان " ممّ " نحلة تطوف بفوافيّ! وكصحراء قاحلةٍ تفاجأتْ بالمطر أنشأتُ أرتشف الهتون الزاخر الأعطاف بما اختزنه من توق دافق!
كان يكرّ، فأجاريه بشغف شهويّ وأفرّ، ثمّ يناله التعب، فيتراجع مُفسحاً لي المجال لأداور وأناور وأكرّ!
وكانت ليلة سكرى بالأشواق وعبيق القبل، حتى إذا أخذ الإرهاق منه كلّ مأخذ، انقلب على ظهره، وراح في نوم عميق!
إضافات على الليلة الأخيرة :
بينما أضاف " ممّ " نفسه ما يمكن أن يعدّه الراوي إضافات تضيء ما قبل الليلة الأخيرة، وليس ما بعدها، إذْ قال :
كانت السنوات تمرّ ثقيلة، بطيئة، ومُضنية، كنتُ خلالها رهين إحساس مرمض بأنّني عود أصابه اليباس، أمّا عدوّي الأكبر ـ إذا استثنيت الذاكرة ـ فكان يتلخّص في كلمة واحدة هي " الزمن " !
صيف أحمق، يليه شتاء أرعن، وخريف أعجف، يليه ربيع لا يشبه الربيع في شيء! فلا تسلني عن البلدان الكثيرة التي قادتني قدماي إليها! ولا تسلني عن قطعات " الانكشـاريـة " المختلفـة التي قاتلت معها في " البوسنة " و " اليونان " و " كريت " و " قونيـة " !
يا الله! كم مرةٍ اكتسى الموت فيها شحماً ولحماً، وواجهني، ولكنني لا أعرف كيف أفلتّ منه! وكم فجرٍ مُكحّل بالغبشة تفكّرت بأنّه الفجر الأخير الذي أشهده! وكم شاقني توق لا يُحدّ إلى أمي وزوجتي! وكم هزّني القلق عليهما في غيابي، فيما الذاكرة تنشقّ عن إدراك حادٍ، بأنْ لا أحد لهما يعتمدان عليه من بعدي، فيتضاعف قلقي، وتروح الأسئلة تقضّ مضجعي متمحورةً في متى، وكيف!؟
كلّ شيء كان يناديني! حجارة الوادي الصماء التي ألفتني لكثرة ما اعتليتها، قزعات الغيوم التي كانت تظلّل كوخنا كلّ حين، الثلج الناصع البياض الذي كان يجلّل هامات الجبال من حولنا، حقلي الصغير، وقطيعي، وقبضة محراثي القديم، أنسام الروابي الوانية، وكنت قد يئستُ من العودة!
ولكنّ الفرج أعقب اليأس على غير موعد، فرحتُ أسابق النَفَس إلى أهلي! أنْ أفوق العين في رؤيتها، أو أستعير من الطير جناحيه، وأحمّل الريح البشرى، تلك كانت ـ لحظتها ـ أمنيتي الأولى والأخيرة، إلى أن وصلت، فأية فرحة!
خاتمة الليلة الأخيرة :
ثمّ أنّ الفجر أخذ يتوّغل في جسد الليل البهيم، وما من مُجيب إلاّ الصدى، ما دفع بالعجوز إلى أحضان إحباط ضاغط، كان البرد قد فعل فعله في الجسد المُهدّم، فاستدارت نحو الباب لتدخل، لكنّها تفاجأت بما رابَها!
أيتها الآلهة صبّي غضبك على هذا الكون المُدنّس!
فمن هذا النائم في فراش " ممّ "!؟
رباه! أية امرأة تستطيع أن تخون رجلاً كمثله!؟
وقال الراوي؛ ثمّ أنّها انتضّت خنجراً، كان " ممّ " قد تركه بحوزتها، وتقدمّت من الفراش تقدّم مرجل يغلي بحقد دفين .كان شعر الزوجة يغطي وجهه، فلم تتمكّن العجوز من معرفة ابنها! كلّ شيء من حولها كان ينضح برائحة الخيانة، يغوص في مستنقع القذارة، ويدفع إلى أعتاب الهذيان، بله الجنون! عالياً رفعت الخنجر، مُستمدّة من سنوات الانتظار والقلق قوة لا تعرف من أين واتتها، وهوت به على صدر الرجل مرّة، لكنّ الأتون المتقدّ في أحشائها لم ينطفىء، ولم يسمح لأذنيها الموشكتين على الصمم بالتقاط حمحمة حصانه، فهوت بالخنجر ثانية وثالثة، مدفوعة بغضب أهوج يسوط الأعصاب ويفتّتها، ثم التفتتْ نحو المرأة الشابة، ورفعت الخنجر بكرب، بيد أنّ الصهيل المتألم تمكن ـ أخيراً ـ من اختراق أذنيها، فتوقفت اليد في منتصف المسافة، وخفت إلى الباب بتعثّر..
ربّاه! لو أنّ هذا العالم الداعر ينفجر!
لو أنّ هذا الزمن الموبوء يتشظىّ!
لو أنّ هذه اليمين المُخضبّة بالدم تُشلّ!
ترنّحت الأرض، ومادت، وغامت الدنيا في عينيها، فتهاوت على ركبتيها جاثية!
آه أيها العالم! أيّ خواء يملؤك!؟ وأي جدوى!؟ أيّ رجاء يُنتظر بعد!؟
كان جواد " ممّ " يرفع قائمتيه الأماميّتيْن مُحمحماً بغضب، كمن يعتزم أن يتسلق حبال الهواء، ويضرب بسنابكه الأرض، يحفرها مُحاولاً التخلص من لجامه، ومن كلّ موضع في جسده كان العرق ينـزّ، بينما كان صهيله يشقّ عنان السماء!
وا ا ا ا ممّو و و و ه ه ه!
سقط الخنجر على الأرض ،وانتشرت صرخة العجوز التي تهاوت جاثية على ركبتيها في الجهات الأربع.
تلك الرائحة
1 ـ إحـالات :
والآن! هل للبكاء كبداية احتجاج جدوى، ليحكيـ ـ من ثمّ ـ حكاية تلك الأمسية الصيفية الحزينة! ؟
أيّة لحظات راشحة بالحزن ورائحة الدم راحت تنـزّ على الحواف آنئذٍ!؟ وأية بدائية وحشية نجحت في الإفلات من قمقمها الثاوي تحت طبقات من التهذيب الُمدجّن والكاذب ؟!
هل كان لحرارة آب ثمّة علاقة بخروج الأعصاب عن مدارها الهادئ، وولوجها مدار الجنون!؟ أم هو الليل يوقظ في الروح أحزاناً بلون البنفسج، ويُهيّج حنيناً إلى القتل كان غافياً تحت ستار من التماسك الهشّ والمُخادع!؟
هل كان ثمّة حبل سريّ بين فورة الدم تلك، وبين ما يُسمّى بالعرق أو الوراثة!؟
المنظر الماثل أمام عينّي ليس حلماً، لكنّه أكثر رعباً من أن يكون حقيقة للذاكرة المُتشظيّة، وكلّ ما يبدو كلوحة فانتازيّة لفنّان مهـووس ، يلوح كثيفاً، لزجاً لزوجة دمٍ فاسد، وها العودة إلى ما قبل الخراب العميم، إلى ما قبل اختـلاط المحيـط المُمعـن في استثـارة الأعصـاب الموتورة، تبدو مُستحيلة!
2ــ الأسئلة :
كيف وصلنا إلى المُفترَق الصعب!؟ ومتى احتكمت اللغة بيننا إلى الصمت النفور!؟ كيف انهار كلّ شــيء في وضح النهار، وبلا استئذان!؟
شيء ما في محيط العمر كان يضمحلّ ويموت، لانقسام في الخلايا، أو تلوّث في الدم الموروث، وكل المُؤشّرات كانت تشي بفجيعة أكيدة، فكيف لم أنتبه إلى أنّه كان ـ هذه المرة ـ مُختلفاً! ؟
كان جوّ الغرفة مشحوناً بالتوتر، وما كان في الإمكان إعادة الأعصاب المشتعلة إلى سـابق هدوئها! وحين تقدّمَ منّي كان ثمّة إحساس مُبهم بأن الأوان قد فات! كان هذا واضحاً في شرايين العينين النابضتين بالاحمرار والغضب، في الارتجاف الغريب الذي سيطر على اليدين، وفي الصمت المُريب المُرهص بنشوب عاصفة!
فُجأة غامَ كلّ شيء، حسّ المباغتة سبق حسّ الألم، فترنّحتُ، ومن الوريدين المُنفغرَيْن للتـّو على جرح عميق، انبجس الدم مُلطخاً الجدران والأرائك والأرضية، ثم أخذت الموجودات تغيب عن بصري!
3 ـ في الذاكرة المنقسمة :
حين وقعت عيناي عليها، انساب في القلب جدول خلتُ أنه قد جفّ!
قلت ك
" سيكون بيني وبينها شأن " !
وكان!
في الأيام التي تلت لقاءنا الأوّل، استفاقت الأحلام الهاجعة في قرارة من الذاكرة، عن فتـاة شبيهة بحقل عشب، فتاةٍ حلم لطالما استعادتها المُخيّلة توقاً مُفعماً بالمسرّات الغامضة والسرية! واختتم الزواج خطبةً قصيرة تمّت على عجل، تخلّلها حفيف ثمل يشعّ بجذوة لذيذة وآثمة، تحت ضغط من التربية الزميتة .
هادئاً، كتوماً، وربّماً مُسرعاً بعض الشيء راح الزمن يخب، وما كان التكهّن ـ بأنّ هذا الهدوء هو ذاك الذي يسبق العاصفة ـ في مدى الرؤية أو الإدراك ، إذْ سرعان ما تبخرت الصورة المُورقة عن امرأة مُضوّأة بالنور والعنبر، سيُكتب لها أن تندغم بفقرات العمر لحساب اليومي المُقيت والمُعاد!
واليوم، فإنّ تحرّي الملالة التي انسربت ـ في الخفاء ـ إلى مكامن النفس، تبدو مهمّة عصية على الاستقصاء المُتأنّي والهادئ، إلاّ أنّ خرّاجاً صغيراً في العمق أنشأ يكبر ويتقيّح! بسبب من التكرار الممجوج ربّما، وربّما بسبب من القصور العام في الأشياء، أو لأنّ نمط الحياة انقلب كلياً إثر الارتباط بكائن آخـر، فتدافع الخلل إلى نبض الدم، واستيقظت جرثومة السأم وسوء الفهم والتحوّل، لتبعثر رموزي وتاريخي الشخصيّ المحكوم بالرتابة، ولتغتال ـ من ثمّ ـ طقوس الوفاء والأحاسيس الحارة، ما كسـر الصبوة! فهل لليقين بأنها أضحت ملك يميني دور في ما آلت إليه الأمور ، أم هُمُ الأولاد تأخروا في المجيء، فانكمشت المشاعر منطوية على عجزها بانكسار!؟ ذلك أن الإنسان يظلّ ـ في النهاية ـ إنساناً، وهذا كلّ شيء!؟
ولكن لماذا أخذت زوجتي تثقل عليّ بمطالبها!؟ تفكرّتُ بمرارة، أهو الغلاء الذي ما فتئ يستاف دخلنا بلا رحمة!؟ داخل مدار الصدمة أخذتُ أتساءل ؛ إن كان لأجريْنا اللذين بدوا عاجزين عن تلبية احتياجاتنا ـ غب الأيام الأولى من الشهر ـ أثر في تداعي ركننا الوادع؟ بيد أن الأمور اختلطت عليّ، وفي لجّة التخبّط تلك ما عدتُ قادراً على التفكّر أو التمييز!
المهمّ أو المُؤسي في المسألة أنّ أحداً ما كان معك، ثمّ لم يعد، تخلّفَ أو خانَ ! ممّا دفع مُوجعات الحزن لأن تتنامى! طبعاً أنا لم آبه كثيراً بالبنطال البالي الذي ما عدتُ قادراً على استبداله، ولا بالجوارب المرفوّة في أكثر من مكان، ولأكثر من مرّة، لكنّ أكثر ما جرحني في العمق تبدّى في عجزي عن التحصّل على علبة من لفافات التبغ أحياناً، أو غياب فنجان القهوة أو كأس الشراب عن منضدتي، شبيهاً بأن تحشر امرؤاً في مضيق الموت كان الأمر، ففقدت مقدرتي على الرسم، وبقيت اللوحة المُعلقَة على حالها عند تخوم التأسيس!
أمّا متى ضربتها لأول مرة، فأنا لم أعد أتذكر على وجه التحديد، مُستثاراً كنت، جاهزاً للانفجار كقنبلة موقوتة عند أي مطلب أو كلمة أو ـ حتى ـ إيماءة ! بعد أن توالج الشجار بحياتنا، وعشّش فيها كطحالب ضارة!
وبكت ليلتها كما لم تبكِ من قبل، فاعتسفني الندم! كان الخيط الرفيع الذي يجمعنا قد تقطّع أو وهى، وتمنّيتُ لو أن يدي شُلت أو قُطعت من قبل أن تمتدّ لضربها، غير أن الأمر ـ بمرور الأيام ـ تكرّر ثانية وثالثة، ليدخلَ في باب العادة، من غير أن يترافق بالأسى الحارق الذي ساورني في المرة الأولى، ثمّ غدا ـ شيئاً فشيئاً ـ تعبيراً عن إسقاط مُبهم أو تشفّ!
ربّما كنّا على شيء من الاختلاف في المشارب، إذْ أنني ـ على نحو ما ـ كنت مهموماً بالشأن العام، فيما لم تكن هي تأبه إلاّ بالخاص والعارض، ما زاد الـهوة التي تفصل بيننا! طبعاً أنا لا أنكر بأنّها كانت أقدر منّي على اقتناص لحظات الفرح البسيط، ربّما لأنّها كانت أصغر في السنّ، بيد أنّ الضرب المستمرّ كسر روحها المُتوثبة، كسر فيها الإنسان!
وإذا كانت الذاكرة قد رسمت في حلمها عشـّـاً حميماً للزوجية، قائماً على ثنائية الزوج والزوجة، فلقد تفاجأتْ بأنّه لم يعد كذلك، إذْ في اللحظة التي كانت علاقتنا تعبر ـ فيها ـ مفازة جحيمها، انبثق الأهلون ولكن لا لكي يعملوا على حّل خلافاتنا، بل لكي يُسهموا في تأجيج الصراع اليوميّ، المُعاش بعريه الصّفيق! وبذلتُ ما بوسعي لأنأى بحياتنا عن تدخّل الآخرين الفظّ والجارح، إلا أنّني اصطدمتُ بجدار صلب من قبل أهلها، فهل كان أهلي أكثر حياداً !؟
ثمّ ماذا عن الآخرين، الذين تفاجأنا بهم عند كل مُنعطف! لدرجة شعرت ـ معها ـ بأنّنا عراة أمامهم! مكشوفون حتى أعمق أعماقنا!؟ وكان أنْ تساءلتُ بغضب ؛ لماذا تسمح زوجتي بهذا كلّه!؟ ولماذا يكون ثمّة امرأة تخدع - دائماً - رجلاً في حضوره أو غيابه!؟ أليس في الأمر خيانة من نوع ما!؟
هكذا ـ على ما أظنّ ـ تداخلت الحلقات مُوقظة مشاعر العداء والقسوة، المُتدارية بمظاهر المصاهرة والمودّة المُزيّفة بين عائلتيْن، ولم يفلح غيابي المستمر عن البيت في إيقاف الانهيار!
4ـ في انكسار الحلم :
كريح تعبر مُنعطفاً بدأت علاقتنا بالخروج عن مدارها الهادئ! وعلى السطح طفا السؤال ؛ عّما إذا كان هذا الرجل الذي يقاسمني الفراش اليوم، هو ذاته الفتى الذي حلمت به عمراً، ممتطياً صهوة حصانه الأبيض ، وقادماً من البعيد ليختطفني إلى حيث حقول الغبطة السارحة!؟
سؤال ممرض يفثأ الدم تنامى كفطر سام، ملقياً بظله الثقيل على الأحاديث الهادئة، التي غابت لمصلحة صمت قاس أخذ يحفر في أعصابنا، فاستسلمَ عالمنا لوجوم واخز وأصمّ!
وفي جوّ التوتر ـ هذا ـ أضحت كلّ خطوة مجازفة، وكلّ عبارة فخاً، ربّما لأنّها خضعت للإرث البطريركيّ، أو الدينيّ، الانتقائيّ والمُجتزأ ، إذْ غابت الآية الكريمة ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل .. ) لحساب الآية ( .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )، فجاءت المُعادلة مُختلة لصالح الذكورة المُهيمنة! وتساءلتُ بحرقة ولوعة عن مكمن الخلل، لكنّ الحبل الذي يربطنا كان قد انقطع!
مهجورةً كنت، ومنكسرة، منذورة للتشتت، أركض بين البيت والدائرة لأعمل وأكنس وأطبخ، فلا يتبقّى لي وقت حتى ألتقط أنفاسي! ولكن ما الفائدة، إذْ لم يبقَ لي في غيابه الذي غدا يفوق حضوره، إلا أن أترك أحاسيسي للنوء!
هذا لا يعني بأنّني لم أحاول أن أضمّد العطب المحسوس، لكنْ غير المُدرك كنهه، وفي لحظات الهدوء التي أنشأت تعزّ، كنتُ أتجرّأ على السؤال ؛ لتحرّي ما بين السطور! كان ذلك في أوقات معينة أستشعرها بحسّي الأنثويّ، بيد أنّ الابتسامة الصامتة، المُحايدة، التي كانت تجبه سؤالي، جامعة سخرية غامضة إلى التسليم، كانت تشير إلى أن لا جدوى!
أما في أيّ فجّ غارَ عالمنا المسكون بالفرح، فهذا ما استغلق على فهمي تماماً، تاركاً محله السؤال ؛ أن ما الذنب الذي اقترفته!؟ ألا أتقاسم معه المسؤولية، فلماذا يعمد إلى افتعال الشجار بداعٍ، ومن غير داع!؟ صحيح أن الأسعار اشتعلت، ولكن ما دخلي أنا في ذلك؟ أنا لم أطالبه إلاّ بالضروريّ من حاجات البيت مُتجاوزة عن الطلاء الذي تساقط عن الجدران هنا أو هناك، على ما يسبّبه لنا من حرج أثناء زيارة المعارف والأصدقاء، وصرفتُ النظر عن تخلخل الأرائك، لأنّني ـ مثله ـ كنتُ على دراية بوضعنا، ومن غير أن ينتبه أخذ الصنف تلو الآخر يغيب عن لائحة الطعام، لكنّني آثرتُ ألاّ ألفتَ نظره إلى الأمر، وبادرتُ إلى التخفيف عنه ما استطعت، إذْ كم من ثوبٍ مهلهل غيّرت فيه ليوحي بأنه ثوب آخر، وكم رغبةٍ صغيرة كبحتها حتى لا تنغّص علينا! حتى في ما يخصّ موضوعة الأطفال، تحاشيتُ الخوض فيها، على شـغفي العارم بهم، لكي لا أجرح فيه حسّ الرجولة، إلا أنه يعرف بأنّني سليمة، وأنّه يشكو ضعفاً في السائل المنوي، يضع مسألة الإنجاب في خانة ( الممكنات ) الصعبة!
أمّا أن يصل الأمر بنا إلى الضرب، فهذا ما باغتني تماماً، وجرحني! مُهانة كنت وُمشوّشة، فالتجأتُ إلى عبّ الصمت، فيما كلّ شيء يتهاوى جهاراً لخلاف الأضداد! في ما بعد، ومع التكـرار ربّما، أخذ الضـرب الذي كنت أتلقّاه منحى آخر، إذْ تحوّل ـ بالنسبة لي ـ إلى نوع من التحدي المُضمر، ممّا زاد في غضبه وحيرته!
بقي أن أقرّ بأنّني لا أستطيع أن أتبرأ من أهلي ـ هكذا ـ ببساطة، بسبب من الخجل، ناهيك عن الوفاء والاعتراف بالجميل، رغم أنني لا أنكر دورهم السلبي ـ أحياناً ـ في خلافاتنا، ربما لأنّ ثقافتنا لا تعفينا من واجباتنا نحوهم، ولا تمنحنا الحق في إيذاء مشاعرهم عند أوّل كبوة!
ثمّ ماذا عن أهله!؟ ألا يدخلون بيننا وبين جلدنا!؟ في الصغيرة قبل الكبيرة!؟ مُتوهّمين بأنّني أصل المشكلة في تأخّرنا بالإنجاب، على جهل منهم بأنّنا عاجزون حتى عن مُراجعة طبيبنا! فلمَ هذا كلّه!؟ ألأنني الأنثى!؟ الجناح المَهيض كما يقولون!؟ ولكن أين المنطق في هذا كله!؟ إلى الجحيم بكلّ شيء! إذْ من يتفكّر في المنطق هذه الأيام، فأنتِ الضلع القاصر، الجارية المُطالبَة بالطاعة والخضوع، بعيداً عن مُثُل الحق أو العدل، وما عليك سوى الاستجابة لنـزوات السيّد ذي السلطة المُطلقة، بغضّ النظر عن مشاعرك وأحاسيسك! لِمَ لا؟ ألستِ الأنثى، المعادل الموضوعيّ ـ في الشرق ـ للبغي!؟ ألستِ ـ سلفاً ـ على لائحة الاتهام، المُطالبة دوماً بإثبات العكس! ؟
ولكن مرّة أخرى ما الجدوى بعد أن انقطعت بيننا السبل، وأضحى الصمت ملاذنا الأخير!؟ فقط لو غادر مُعتكفَه النفسيّ قليلاً، لو تخلّى عن شرنقته، وسمح للّغة بأن تمتدّ بيننا، عندها لأقنعته بأنّه مُخطئ، وأنّني مثله لا أريد لأحد أن يتطفّل على حياتنا، لأنّها لا تخلو من الخاص والمُخجل الذي ينبغي أن يظلّ سراً! ولعبّرتُ له عن حاجتي إليه، عن تحرّقي للمساته الراعشة على جسدي، وعن توقي المشحون بالرغبة إلى كلمة ناعمة مُنداة تشـعرني بكينونتي، بأنّني ما أزال تلك الأنثى المحبوبة والمُشتهاة!
وبعـد! أين أذهب بـهذا الجسد الثائر كبركان حبيس!؟ هذا الجسد الذي ما يفتأ يلحّ على مطالبـه كل حين، مُهتبلاً أيّ ثغرة لكي يعبر منها، ويئن محتجاً على الإهمال والفوات، فأستيقظ عند غبشة الفجر على ندائه، لأتفاجأ به حاراً ندياً، موّاراً بالرغبة! وأتفكّر مُتسائلة باستغراب وألم ؛ من أين يمتح هذا الصراع تلك القسوة والشراسة كلها!؟
5 ــ تراتيل للمرثية الناقصة :
المنظر الرهيب حقيقي إذن ! والمرأة الحبيبة التي كانت إلى ما قبل لحظات تعجّ بالحياة، أضحت جثة هامدة!
أنت لا تعرف كم من الوقت مرّ إثر ذلك الإعصار، لأنّ حالة شبيهة بالتشقق في الزمن كانت تمور في الجوف! حالة تقع في العمر مرّة ربّما! حتى ذريرات الهواء استكنّت لها بفزع شديد! وها أنت كفنان تعامَلَ مع الموت على أنّه الوجه الآخر للحياة تشعر بالخوف، بالخوف والعجز معاً! ذلك أنّك ما إن بدأت تعي هول ما اقترفته يداك، حتى صرختَ بلوعة وألم كمن تلقّى طعنة سكين في خاصرته، ومع الصرخة امتلأت كفاك بخصلات من شعرك اقتلعتها من غير أن تشعر! أمّا كيف سمحتَ لأعصابك بأن تفلت، وكيف تفاقم الشجار بينكما إلى أن أطلّت اللحظة الطائشة برأسها! ثمّ كيف سعت الذاكرة المنقسمة إلى أن تضع يدها على السبب! فأنت عاجز عن الإجابة، إذْ خارج العناد الأرعن والموروث المرمض لم يكن ثمّة داع لنذير الدم ذاك! ومثلما ارتفعت الصرخة كدوي رعد، غمر المكان - كله ثانية - صمت حاد!
كيف انقضى الليل! ومتى دخل الفجر بغبشته!؟ هل كنتَ تتمعّن في ملامحها قبل أن توارى طيّ التراب!؟ فأنت أيضاً لا تدري، إذْ أنّ الموت بمعناه الماديّ، الكلّي الحضور كان يملأ المكان، ويغلق الأمداء برائحته الخاصة!
آه، أيها المأفون، هل تدرك بأنك قتلتَ المرأة التي تحب، فكيف لك أن تمضي في العيش بعد!؟ كيف استطعتَ - وأنت الفنان المُرهف - أن تقدم على ما أقدمتَ عليه!؟ ولكن هل حقاً أنت كذلك!؟ إذن لِمَ لمْ تستطع يوماً أن تعّرف الرسم - ببساطة - على أنّه خطوط مستقيمة ومنكسرة!؟ ألم تخدع نفسك من قبل أن تخدع الآخرين عندما تطفّلتَ على التكعيبية، وأنت تجهل من الرسـم المنظور!؟ وهل كنتَ حقاً على صلة بالشأن العام!؟ لماذا ـ إذن ـ لم تدرك بأنّ أسّ المشكلة لم يكن بينك وبين زوجتك، بل كان في مكان آخر!؟ أما كنت - كغيرك - دعياً، تنادي بالحرية والمساواة شريطة ألا يتسللا إلى بيتك!؟ لندع الشأن العام جانباً، أما كنتَ ترى في نفسك رجلاً!؟ حسناً، لماذا كانت رجولتك تلك تظهر فقط على من هم أضعف منك، وتغيب أمام رجال الشرطة والأمن، الذين كنتَ تخافهم خوفاً يمسخك إلى شخص مسكين ودارج!؟ هل خرجتَ - أبداً - عن إرث الأسلاف، وانتظمتَ مع زوجتك في شراكة حقيقية تقوم على التماثل لا الامتثال!؟ ألم تكن - في نظرك - دائماً جزءاً من قطيع الحريم المُقتطع من ضلعك!؟ بعضاً ممّا ملكت أيمانكم داخل حسّ التملّك المريض والمنحرف، القائم على الآية الكريمة ( الرجـال قوّامون على النساء بما فضّلَ الله )، ذاهباً إلى أن ( فضّلَ ) هنا هي فعل تفضيل مُؤسّس على الأحسن لا الأكثر تقوى!؟
لقد قتلتَ حبّك، فهل تستطيع أن تعود بالزمن إلى ما قبل ارتطام الجهات، لا لشيء إلاّ لتقول لها بأنك ما تزال تحبّها، وأنك لن تستمرّ في الحياة من بعدها، أنّ الوقت أمامكم كان ما يزال مُتاحاً لإنجاب طفل أو أكثر!؟ الآن - فقط - أيقنتَ بأن الأطفال، هذه الظاهرة التي تبدو اعتيادية جداً، تنضوي على مغزى الحياة العظيم! والأطفال يعنون أسرة، رجلاً وامرأة وأولاداً، فماذا أبقيتَ من هذا كله!؟ كيف استطعتَ أن تواجه نظرات الرعب والدهشة والعتاب والألم التي أطلّتْ عليك من حدقتيْها!؟ أيّ ألم مفترس لا يعرف الرحمة أو المنطق ينتظرك، وأيّ ندم، بل أيّ جنون!؟ ربّما لا أمل يا صاح، ربّما لا أمل! إنّها الأرض تنادي أبناءها الذين تأخّروا عنها، فهيّا، إذْ لم يعـد ثمّة وقت، هيّا اقفز لكي ترتاح، اقفز ولا تكن جباناً!
وكما يرى نبيّ الوحي فُجأة ، فيجفل ويرتعد، رأى على نحو ُمبهم موته الأكيد القادم ذات أمسية صيفية كمرثية حزينة! كانت عتمة الليل تبسط سطوتها على الكائنات ، وتطمس ملامحها، وفي هدأة منه ارتفع صوت شجيّ لثمل شالته حالة من النشوة والأسى الشفيف! وحده الليل كان شاهداً على الجسد الذي انقذف في الفضاء بكل ما أوتي من قوة وحزن وغضب وحسرة، ليرتطم بالأرض الصلدة، لكنّ الفجر أخفى صوت الارتطام المكتوم تحت عباءته الفضية .
30/6/2000
لذاكرة مُكتظة بالدمامل على نحو ما
متوالية قصصيّة
إلى غازي برهوم .. سامحني يا أخي، فلقد كان الميراث المعمد بالدم ثقيلاً، ولم أكن أملك سوى هاتيك الكلمات وبعض دموع، فسامحني واغفر لي!
* فصل الرحيل :
على البعد، على البعد وفي عمق المشهد، كانت الأقدام الخائفة تدهس أنصال العشب عند أطراف الوادي المنحدر، عند الأطراف تماماً وكصورة سينمائية أبطئت حركتها تحت سماء شزرة، شزرة وزرقاء بشكل فظّ، كان الرجل يهرول مُحتضناً صغيره على نحو ما، لكنّ طرفيه، الطرفيْن السفليَيْن للصغير كانتا تتدليان كخرقة مبلولة ، وفي الخلف،، في الخلف نحو الأعلى، ربّما لأنّ الرجل بدأ ينحدر سريعاً نحو الوادي، أو لأنّ المرأة كانت تركض بتثاقل، تتعثر.. تتعثر، فتعلو ضفائرها نحو السماء كجناحين كسيرين لطير مَهيض، وترتفع يداها بشكل لا إراديّ، ترتفعان - ربّما - لأنّهما كانت ترومان توازناً مُفتقداً!
إلى أن لاح لهما نهر الأردن في الشرق، وبدا لهما مُتجهّماً لسبب ما مجهول!
وعلى نحو مُباغت توقفَ الرجل.. توقفَ، ليدير عيني حائرتيْن دامعتيْن في سماء مُحايدة، سماء مُحايدة كانت رؤوس الشجيرات وذرى المرتفعات المُتكسّرة تخترقها على تفاوت..
هل أراد أن يقول : " لا! "
أن يحتجّ مثلاً، أو يحتدّ مُعترضاً!
ألهذا أنشأت الذاكرة تستعيد بطريقة سيئة ومُتداخلة - ربّما لأنّها تفاجأت بحصار اليهود للقرية، التي ما فتئت تتمسّك بحافة المنحدر على جزع - صورَ القتل، صور القتل والدمار!؟
هل عجز عن شرح الواقعة لزوجته، فتشبثت عيناه الغؤورتان المُحتكمتان إلى اليبس بالصخور الناتئة والنافرة على نحو مُبهظ، ثمّ تابعت قدماه المتقصّفتان هرولتهما بصورة أبطأ!
ولكّن متى!؟ متى وأين!؟
لقد اختطفَ الصبيّ على عجل، وأومأ لزوجته المرعوبة أن الحقي بي، فمتى وكيف وأين!؟ مُتفاجئاً بسائل دافىء راح يخضّب قميص الصغير فقميصه أنشأ يتساءل بذهول! وعندما وضع يده الراعشة على قلبه، تماماً على قلب الصغير، ترنّحت الأرض تحت قدميه، ترنّحت ومادت أو ارتطمت بماء النهر في أسفل الوادي، هناك.. في الأسفل حيث كانت الأرض تتدثر بخضرة داكنة!
ألهذا - مثلاً - راحت الذكريات تنفر من شقوق المُخيّلة، وتهوّم كخيول رامحة في عراء ليس له نهاية!؟
* مقدّّمات لفصل الرحيل :
هناك.. قريباً من بحر فيروزي، راح يتوسّط الجهات، كان ثمّة فندق عريق، وهناك في الداخل، هناك في الجهة المطلة على البحر، تماماً في الجهة الـ، كان ثمّة جناح ملكيّ، جناح تتكلف المنامة فيه ألفي دولار لليلة الواحدة !
وفي أصل من ذاكرة الكبار، في أصل منها، أو في فرع، كان الفندق قصراً لآل محمد علي باشا، أمّا الجناح فكان ينضوي على غرفة نوم الملك فاروق، آخر حاكم في سلالة ملعونة، هناك كان الملك ينام، نام الملك فاروق - إذن - تاركاً جنوده لرمال سيناء تذروهم على أصابعها، راحت الرمال تذروهم ثمّ تدفنهم، غبّ رصاص ما طفق يرتدّ نحو النحور ، كان ذاك إبّان حرب وُسمت بالإنقاذ، حرب خيضت ضدّ المُحتلين الصهاينة، لكنّ مكر التاريخ - بعيداً عن هذر الجغرافية - وجّه الرصاص ، أو ما يُشبه الرصاص- في ما بعد - إلى شخصه على نحو ما بجريرة ما فعل!
* في التفصيل على المقدمات:
هو كان ابن عائلة عريقة تقليدياً، بيد أنّه تفاجأ بما حصل حدّ الذهول والانخطاف معاً، وفي التوّ سقط في الرُجعى، فاستعادت المخيلة - في جملة ما استعادت - تعليق شقيقه الساخر " أن كفاك كذباً، فأنت عاجز - حتى - عن استعادة قطعة أرض تخصّ العائلة!" إذاك كان خطابه الناري يُسطرُ مفرداتِه - عن أرض سليبة ستُستعاد - يُسطره برماد مُطفأ، وراحت صور مُتقطعة لتصفيق جمهور هادر يطعن القلب كشفرات رهيفة!
حدث هذا غبّ استفتاء أو إحصاء قامت بها حكومة ما، في عهد ما، في مكان ما، في زمان ما، وعلى عادتها وسمتها حكومة أخرى، حكومة أخرى تلتها بالرجعية، من غير أن تلغي نتائج ذلك الإحصاء، ولأنّه كان ما يزال متفاجئاً حدّ الذهول والانخطاف، لأنّه كان مُتفاجئاً، نسي أن ينبس ببنت شفة، فهمس الأخرون في أذنها، أذن الحكومة طبعاً " ولكنّه كان في الأمس القريب رئيساً لأركان جيشكم، فكيف سقط اسمه من لوائح المواطنة، كيف سقط ليتهاوى كورقة خريفية تهرأت في خانة أخرى!؟"
* تفصيل على تفصيل :
لقلب مجيد فصل من الانكسار، إذ هي ذي فقرات العمر تشرف على خريف أعجف! وها أنت يا مجيد صنو الجنون، فمن يُقايض عرق الحنطة بقطعة أرض في براري الله الوسيعة!؟
وها هم أهلوك - كعهدك بهم - يتجاهلون هذرهم عن جنونك، ويلحقون بك كنزيف، نزيف مدرار خلّفَ وراء الظهور المحدودبة عقداً من القرى، عقداً ترابياً من القرى التي خوت أو تكاد!
فهل كنتَ تعاندهم، وأنتَ تقايض جهد بائع جوّال كنْته- هذه المرّة - بمُربّع أرض، مُربّع آخر في مقاطعة أخرى!؟ هل كنت تعاندهم، أم أنّك كنت ترى إلى ما لا يرون!؟
ولكن أن تخذلك مفاصل القدميْن، وأنت لم تفرغ من قراءة كتبك الصفراء القديمات تلك، وأن تغيب إذاعة حبيبة إلى القلب ذات فجأة، أن تغيب كتبك القديمة والإذاعة دفعة واحدة، فتقف على الحواف منتظراً الأفول، فقط مُنتظراً كما قمر مُنكسر أو كذئب كسيح، أن تخذلك مفاصل القدمين آنئذ، فذاك أمر جلل!
وها هو الجنى يسفر عن هباء، هباء ولا شيء غير الهباء، إذاك كانت الدروب بينك وبين السجن سالكة مُعبدّة، سالكة كانت، فكانوا يلعنون الساعة التي استقرّ رأيهم فيها على اعتقالك المتوالي كحبات سبّحة، هم يلعنون و أنت تكفر بهم، تكفر بهم جهاراً!
وها أنت ترتب حلاً للمعضلة على طريقتك، فتلقي بمتاع زهيد - اسفنجة رثة، وبطانية فقدت ألوانها بسبب الحياء ربّما، أو تحت وطأة عمرها المديد، ووسادة غادرت ريشها منذ أمد - تلقي بمتاعك الزهيد هذا فوق ظهرك، وتقف كنبتة إثل، تماماً كنبثة إثل بجانب جسر هرم أوكل إليه حراسة المارين من وإلى، من بيوت متعبة مصدورة إلى بلدة فتية خجولة وحرون!
وها هي عربة الدوريّة تقطع الجسر في طريقها، تقطعه لاعتقالك للمرة الـ ..للمرة الألف ربّما!
وها أنت تنادي على رئيسها، تناديه، فتتوقف العربة بسبب من دهشتها، تتوقف،لتجيبه بأنك كنت تنتظرهم!
وها هو رئيس الدورية يُخفض رأسه كالمُتألم ربّما، أو كمن اكتشف - للتوّ - مدى التلف والحيف اللذين ألحقوه بأعصابك!
وها هو يرفع رأسه أخيراً رابتاً على كتفك، ليُسرّ إليك بصوت خفيض، وهو يغمز لك بهدوء باسم يشبه التعاطف على نحو ما :
” ألم نتأخّر على المفرزة يا رفيق مجيد!؟”
* فصل التشظي والجنون:
ولأنّ ما حدث كان يفوق طاقته على الإدراك، طاش في فلوات وسيعة لا يعرف مسالكها أحد!
ولأنّ ما حدث كان موغلاً في جسد الغرابة، راح الأهل يبحثون عن ابنهم الفقيد، راحوا يبحثون عنه بلا جدوى كالخذروف، أمّا كيف وقعوا عليه ذات فجأة.. وأين أمضى ذينك الشهرين الطويلين، ولماذا اعتقل الصمت لسانه تحت عباءته الصامتة البكماء.. صمت مُدوّ وفارق، ولماذا كان يفيق عندما تسبل المنازل جفونها، لماذا كان يفيق غارقاً في لجّة من العرق، ليصرخ وينشج بحرقة ما بعدها حرقة!؟ فلا أحد على وجه التحديد يستطيع أن يُضيء تلك الأسئلة بقناديله المُضيئة!
في ما بعد.. في ما بعد، وبالتدريج ستستعيد ذاكرته تفاصيل كابوس لا يُحتمَل، كابوس سيزرعه في دائرة من دهشة، لم تُعْط الوقت لتفصحَ عن هُويّتها، إذ كيف لقوم انقسموا شيعتين، في مسألة تنتمي إلى حقل التاريخ لا الجغرافية!؟ كيف لهم أن يمحضوا بعضهم حقداً خالصاً، حقداً شبيهاً بحقنة سمّ زعاف!؟ حقداً سيدفع بطرف منهم إلى تفريق الجمع إلى جمعَيْن، فيصْطفُوا رهطهم ، يصْطفُونه ويحذفون الفرقة الأخرى بدلالة رصاص ضاغط، رصاص لم يتردّد أبداً في الإسراع نحو الصدور العزلاء كخرافة!؟
ولأنّ المكان كان ضيّقاً كخرم أبرة، أو لأنّ العدد المحشور في مضيق الموت كان كبيراً،لأنّ المكان، أو لأنّ العدد .. لم يعد يعقل كيف ألقى بنفسه على عجل في وجاق النار المُطفأ، ولا كيف ألقى زميل له بنفسه فوقه مسوطاً بالهلع والرعب والدهشة والاستنكار!
ولأنّ المكان كان ضيقاً وكتيماً، ولأنّ الجسدين اندغما بفعل الخوف، الخوف والضيق وأحاسيس أخرى استعصت على الفرز آنذاك، أعياه معرفة مصدر الدم الساخن، الذي راح يُخضّب جسده في غير مكان، ربّما لأنّه- لوهلة - توهّم بأنّه هو الذي ينزف، ربّما لـ، لكنّه- وإلى الآن - لا يعرف كيف نجا من الإرث المُعمّد بالكراهية والدم، ولا كيف هام في البراري لشهرين طويلين.. طويلين!
ولأنّ الميراث كان ضاغطاً، تداعت إلى ساح المخيلة مسرحية مماثلة.. مسرحية ذات فصول بغيضة، شهدتها مدينة ما، في مكان ما، في زمان ما، في قطر عربيّ ما، ولكن بعد أن تبادل ممثلوها الأدوار بصخب, وعلى نحو مفرط !
* فصل من سورة النساء :
أنّه جاء في كتب التاريخ كافة، تأسيساً على أنّهن قد خُلقن من أقمار مكسورة ونبيذ وأقحوان وعنبر ودهن لوز، بأنّ الأمهات الفلسطينيات إذ انشغلن بصناعة القنابل، قنابل قيل بأنّّها قُدّت من حجارة سجيل، ربّما لأنّهن كنّ ينتمين إلى خير أمة أخرجت للناس، كان ثمّة أمّهات أخريات في مكان ما.. في زمان ما .. في قطر عربيّ ما أو أكثر، قد اقتعدن رصيفاً ما، في شارع ما، يعرضن عليه باقتي بقدونس- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عليّ - بل جرزتي بابونج، أو ثلاثاً من علب الكبريت، أو من دخان مُهرّب، دخان احتاس الجميع في معرفة الطريقة التي عبر بها الحدود! مُضيفاً بمكر ربّما، وربّما بأسى، بأنّهن كنّ قد نسين كل ما يتعلق بتاء التأنيث الساكنة من زينة ، و قطعن نون النسوة، تلك النون التي كانت مُتشبّثة بأذيالهنّ بعناد، بيد أنّ رائحة طيبٍ ظلت تفوح منهنّ، ربّما - والكلام ما يزال بيمين عبد الله - لأنّهن كنّ كالسمك، ما برحن يتحمّمن كل سنة مرة، وبشيء من إسراف مُكابر!
* فصل الهُويّة :
ولأنّك بدوي من مقام البساطة، ولأنّك بدوي واضح وضوح طلقة مُسدّس، ولأنّك أقرب إلى الفطرة الأولى والسذاجة الأولى والأرض العذراء البكر، أعياك استيعاب النظرة المُطلة من عينيّ المُوظّف، تلك النظرة المُطلة من عل، أعياك الاستيعاب وأربكك، بل وأخافك بعض الشيء!
ألهذا أضيف إلى مواطن خيباتك الخصيبة انكسار جديد!؟
ألا يكفي الحرمان من لحم مشويّ راح يبهظ الذاكرة بغلاء مباغت، وأنت الواهم بحلم بسيط مع كل نزول نحو بلدة ثرّة، أن تملأ بطنك الخاوي بلحم لذيذ.. حلم بسيط ولكن عزيز!؟
بيد أنّ جاركم ذنون حتو رجل طيب وشهم.. رجل طيب، نعم ..طيب وكريم، فلماذا رمقك الموظف بتلك النظرة الشزرة المُستنكرة!؟
ثمّ أنك لم تقل شيئاً خطيراً، فإلامَِ ذهبت به المظان!؟ فقط كان الفضول يسوطك بقوة، فسألته ببراءة طفل.. أن أين ستذهبون بالبطاقات الشخصية القديمة، غبّ أن استُبدِلت ببطاقات جديدة.. جديدة ولامعة على نحو مُفرط!؟
ولمّا جاءك جوابه بأنّها ستنتهي إلى الفرم، فلا يبقى منها سوى نثار تذروه الرياح، عندما جاءك جوابه ذاك، أفلتَ منك السؤال بدهشة طفل، أفلت كنابض، تماماً كنابض مشدود..
أنت لم تكن تقصد.. مُؤكّد أنّك لم تكن تقصد، ثمّ أنّك لم تكفر بالآلهة.. أليس كذلك !؟ فقط، وببراءة ما بعدها براءة واجهته بالسؤال :
" ولكن لماذا لا تمنحونها لأولئك الذين يحملون بطاقات حمراء..!؟ "
*وللهذيان فصله :
وكان أن جاء زمان عجيب.. زمان لا يشبه ما قبله، ولا يتصل بما بعده، ربّما لأنّ منكراً ونكيراً غادرا كتفيك على سبيل احتجاج عبثيّ، أو لأنّ الأرض أخذت تتعرّق من فرط الخجل والتوتر والغضب، وإمّا أمسكتَ بالأشياء راحت تتقصّف على نحو مدهش، حتى دويبات الأرض أنشأت تنفر، فأن يُنكر الابن أبيه، أو أن يطعن الصديق صديقه في الظهر، تماماً في منتصف وأسفل الظهر، فهذا وارد، لأنّه تواترَ مراراً على نحو ما متشابه، مُقيت نعم بيد أنّه مُتشابه، ولكن أن ينقسم الجمع بين هذا الفصيل وذاك، وأن يلصّ الشقيق روح شقيقه الطهورة برصاص غفل، لا لشيء إلاّ لأنّ هذا ينضوي تحت جناح " فتح"، وذاك يميل جهات " حماس"، فلقد أعيا الأمر الأم الفلسطينيّة, وقصم ظهرها على نحو مُبرّح، فتهاوت على التخوم بين قطاع وضفة!
* خاتمة فصل الرحيل :
ولم يشأ أن يخبر زوجته بمصابهما الكبير، هو لم يشأ ذلك، فتابع مسيره الواهن فوق أرض سكرى راحت تترنّح، وسماء مُتماوجة وزرقاء - أو مزرقة - على نحو غريب، وأخذ النهر المتعرّج كذيل أفعى مُعمّرة يدنو، كان النهر يقترب، بيد أنّ السرّ الضاغط أنشأ يُثقل على فؤاده المُثخن، لقد تأكّد له موت وحيده، فحتّام يُخفي المصاب عن زوجته!؟ أكثر فأكثر أنشأ النهر يقترب ، وإلى الشرق منه، إلى الشرق تماماً، كانت الحافة الشرقية التي تحدّ الغور، تتخلق على صورة حيوان خرافيّ ضخم، أو ضرع بقرة مُتعدّد الرؤوس ، تنهض على نحو نافر ووعر، إنّها الأرض التي ترتمي إلى الشرق من نهر الأردن إذن..
" ولكن لماذا أيها الإله الرحيم!؟ لماذا.. ولمصلحة من !؟ "
مُبرّحاً كان السؤال، ومُبرّحاً كان الجواب المؤسي، مُبرّحاً إلى درجة استحال معها التكتّم أكثر، فالتفتَ إلى الوراء، التفتَ ليُفضي إلى زوجته بالوشل المدمّل الذي أخفاه خفق الضلوع، التفت لـ... وراعه أن لا أحد كان هناك، هناك حيث ينبغي لزوجته أن تكون، فانصعقت ذريرات الوعي، التي أعياها اكتناه الموقف
" ولكنْ هذا - على نحو ما - غير منطقيّ.. غير منطقيّ وغير عادل أيضاً ! "
انصعقت الذريرات، وهبط قلبه نحو القدمين، نحو القدمين تماماً، وبهلع مُتوجّس تململت عيناه في محجريهما لائبة.. فهناك.. هناك عند المنعرج، هناك حيث تُغيّبُ شجيرات قصيرة وكثة ملامحَ الدرب، كان ثمّة جسد مُتكوّر.. مُتكوّر ومُتكوّم على ذاته بشكل فظيع ، ربّما لأنّ الألم الذي ناله إثر الرصاصة الغادرة، ربّما لأنّه كان مُبرّحاً، وفي المسافة التي بدت - آنئذ - شاسعة وباهتة، تلوّنَ المشهد بأحمر شبيه بالحناء.. أحمر كالحناء ولزج، فخوّض في الماء إلى الركبة، وكم شعر - إذاك - بالعطش.. بالعطش والاختناق، وعلى نحو ما تهاوى ببطء نحو الأسفل ، وأفلتتْ يداه جسد الصغير البارد، أفلت جسد الصغير الغضّ والبارد، ليرتفع في الأمداء عواء إنسانيّ مديد.. مديد!
أصداء
ـ 1ـ
وكان أنْ جاءت كتب التاريخ في متونها على ؛ أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) استفاق من قبره البسيط، المجهول ربّما، فنفض التراب و الغبار عن شعره ولحيته!
لم يكن ثمّة وجه للشبه بين الرجل ذي الكفن الرثّ، الذي اشتهر عنه ميله إلى الزهد في مأكله و ملبسه ؛ مذْ تسنّم سدّة الخلافة، غداة أن توفّي أبو بكر الصدّيق ،والرجل الذي كان ذات يوم من رؤوس القوم في بني عديّ ؛ إذْ كان ذاك لايقرب من اللباس إلا الخزّ و الحرير، و لايخرج إلى الناس إنْ لم يتطيّب بالمسك أو العود أو العنبر، ما يليق بموفد قريش المُفوّض إلى امبراطوريتي الروم و الفرس .
كانت الحرب الضروس بين الدولتين تقطع الطريق على تجارة المشرق و المغرب، فأخذ سفير مكّة ـ ذاك ـ يعمل على إبرام اتّفاقيات ؛ تيسّر السبل أمام قوافلها التجارية، فتلعب دور الوسيط بينهما، بما يضع حرير الصين وخزفها، وتوابل الهند وبهارها بين يدي الفرنجة، وذلك عبر جزيرة العرب ؛ بعد أن تكون قد قطعت بحر الروم .
و راحت خزائن قريش تمتلىء بالبضائع من كلّ صقع، و هيمنت قوافلها على تجارة الشتاء مع اليمن السعيد، وما يليه من طرق بحرية، تصلها بالهند و ما ورائها، و تجارة الصيف الذاهبة جهات بلاد الشام، فبلاد الروم و الفرنجة وما كان الأمر بعيدا عن دور شخصيّ لرجل من مستوى ابن الخطاب .
و كان الخليفة الراشدي الثاني قد غادر المسلمين إلى الملأ الأعلى، وهم بأحسن حال، فلقد خلق من حفنة أعراب ، لايُحسب لها حساب، كانت قد اجتمعت تحت راية محمد بن عبد الله ، دولة مرهوبة الجانب؛ فقضى على دولة الفرس، وعملّ على ضمّ العراق و أرمينّية وأذربيجان إلى الدولة الإسلامية الوليدة!
و جاء في التفاصيل :
وكان التوفيق حليفه إذْ نجح في انتزاع بلاد الشام من أيدي الرومان ؛ غبّ المعركة الفاصلة، التي وقعت عند ضفاف اليرموك، فكان أن وقف هرقل عظيم الروم يخاطب برّ سورية بأسى ما بعده أسى " الوداع ياسورية وداعا لالقاء بعده "!
ولمّا رفض أهل بيت المقدس من النصارى، أن يُسلّموا مفاتيح مدينتهم لأحد خلا الخليفة، وذلك لما سمعوه عن حلمه و عدله، ركب ابن الخطّاب إليهم مُلبيّا، و كان ما كان من أمر الوثيقة التي تؤمّنهم على أرواحهم و أموالهم وأعراضهم وعقيدتهم .
ثمّ أنّه استجاب لإلحاح ابن العاص ، ليقوم بضمّ بلاد الفسطاط، بعد أن طرد الرومان منها أيضا!
هذا ما كان من أمر الخليفة ؛ الذي أحدث ديواناً للجند ؛ بعد تفكّر وتدبّر، لكي يُنظّم أمور الجيش، وذلك لإدراك منه بأنّ هذا الجيش هو ركن الدولة وحرزها، ثمّ عمد إلى الأرجاء المترامية ؛ يقسّمها على أصابعه إلى ولايات، و يتخيّر من الصحابة من يراه أهلا لإدارة شؤونها، فيوليه عليها!
كان العدل يُهاجسه، ومع العدل الرخاء و الأمان، فانتدب لكلّ مصر قاضياً مشهوداً له ؛ بأنّه لايخاف في الله لومة لائم، فيحقّ الحقّ، و يبتّ في الخصومات، ومن بعدها بثّ في ليل المسلمين العسس، ليأمنوا مُطمئنّين على أموالهم ، آمنين أرواحهم!
ولهذا نهض الرجل من موته مطمئنّا، خليّ البال، فلم يكن ثمّة ما يُشغل تفكيره ـ اللّهمّ ـ خلا سؤال صغير مؤرق ؛ يحوم حول السبب الذي حدا بأبي لؤلؤة إلى الغدر به! سؤال آخر كان يلحّ عليه يتعلّق بظروف انتحار أبي لؤلؤة! هل انتحر الرجل ـ حقاً ـ خوفاً من ابنه عبيد الله! ؟لقد كان ابنه ـ ذاك ـ غائبا عن المسجد في شأن من شؤونه، فمن أنبأه ـ و هو المعروف برعونته ـ بالخبر! ، وكيف حضر، ولمصلحة من دُفنت الحقيقة مع جثّة القاتل!؟
و اختتمت الكتب أخبارها بالقول :
وعلى حافة قبره جلس الخليفة الجليل يُعمل تفكيره في دلالات ما حدث! مُغضباً كان وحزيناً ؛ آنَ تقدّمَ منه فارسان، تبدو على سيمائهما المهابة، و كان أن بادراه بالتحية..
ـ السلام عليكم يا أمير المؤمنين!
و رفع الصحّابيّ الجليل عينين أسيّتين، ثمّ تحاملَ على نفسه مُرحّبا..
ـ من! الرشيد، أنت! و أنت يا صلاح الدين! وعليكما سلام الله و بركاته.
ـ 2 ـ
و أتت كتب التاريخ في معرض ما أتت عليه؛
أنّ الرشيد كان أعرف الناس بشهوة السلطة على النفس البشرية! فلقد اكتوى بنارها، إذْ حاول شقيقه الهادي أن يخلعه عن ولاية العهد لمصلحة ابنه ، و كان بخبرته الطويلة، ودرايته بخفايا النفوس، و مراكز القوى المُحتجبة خلف مصالحها ؛ متدارية بلبوس الوصاية الدينية ، أوبلبوس العصبية القبلية، أو عبر استفاقة الحسّ الأقوامي ، أدرى الناس بلعبة التوازنات الخفيّة، فنفض عن جسده غبار الموت، و اندفع خارج قبره الفاره ؛ المكسو بالرخام المُجزّع، و كان جلّ ما يشغل باله هو أمر تلك الصحيفة ؛ التي عهد فيها بالخلافة ـ من بعدهـ ـ لأبنائه الأمين فالمأمون فالمُؤتمن ، و أشهد عليها الفقهاء و القضاة وأكابر بني هاشم وأمراء الجند، ثمّ علّقها على جدار الكعبة!
وانسلّ نحو دار الخلافة ؛ يتسقّط الأخبار، كانت بغداد قد تغيّرت كثيرا، حتى كاد أن ينكرها، وسرعان ما وقع بين أيدي البصّاصين المنتشرين في كلّ مكان، فاقتادوه إلى القصر، وهم يسخرون من ادّعاء الغريب بأنّه الخليفة الرشيد، فلقد توفيّ الرجل، ودفنوه في باطن الأرض بأيديهم! و ما إنْ وقعت عينا الابن ـ أعزّه الله ـ على أبيه ؛ حتى أخذته رعدة، وأنشأ يرتجف كورقة في مهبّ الريح، و نهض متعثّرا؛
ـ أ..أبتا..ا..ه !
و بصوت جهوري مُستنكر سأله الأب؛
ـ ماذا فعلت بشقيقك أيها الأمير!؟
وأدار ظهره لمجلس المأمون يروم الخروج، فلحقه الابن مُوضّحا مُستعطفا..
ـ أقسم، أنّه هو الذي بدأ الخلاف يا أبت! لقد أراد عزلي! لم أكن أريد قتله، و لكنّها إرادة الله ....لقد أراد أن يعهد بالخلافة لابنه! أنت نفسك عانيت من هذا، و ...
و أمعن الأب النظر في ابنه، ثمّ هزّ رأسه بأسى قائلا :
ـ ولكنني لم أقتل شقيقي يا ولدي ! ثمّ دعك من هذا كلّه، فهل ستترك أمر الخلافة من بعدك لأخيك المُؤتمن!؟ أنت تتدبّر أمر إسناد ولاية العهد إلى شقيقك المُعتصم، أليس كذلك! ؟
فوقف المأمون مأخوذاً، فيما تابع الرشيد خروجه ؛ إلى أن استعاد الابن روح المبادهة، فلحق بأبيه..
ـ إلى أين يا أبي ! ؟
و مرّة أخرى هزّ الرشيد رأسه، بعد أن حدّق في ابنه مطوّلا..
وهل للميت إلا قبره !؟ هذه ليست دنياي،
فانس الأمر ياولدي! انّه القدر ربّما...
ووقف المأمون في منتصف المسافة مذهولا، بينما كان ظل ّ الأب المُتطاول ينأى بابتعاده عن مصدر النور، و يتلاشى!
ـ 3 ـ
وجاء ت الكتب ذات الأوراق الصفراء في متونها، أنّ الناصر صلاح الدين، غبّ مقتل أسد الدين شيركوه ، ووفاة نور الدين الزنكي، أدرك بحصافته المعهودة بأنّ المصاب جلل، وأنّ اللحظة الحاسمة للملمة شمل الأمة قد أزفت، فإمّا أن يلتقطها، وعندها يكون لكلّ حادث حديث , وإمّا...! ذلك أنّ الدولة الفاطمية كانت تحتضر ، و كان لابدّ من جبهة إسلامية عريضة تتصدّى لهجمات الفرنجة، الذين كانوا قد زرعوا أسافين أربعة على ساحل بلاد الشام، كان آخرها أمارة بيت المقدس، فلم يتردّد في القضاء على الفاطميين ؛ ليتسنّى له أن يوحّد برّ مصر وبلاد الشام في كيان واحد، وليضمّ إليها ـ من ثمّ ـ الحجاز الشريف وبلاد اليمن!
وهكذا قيّض له أن يستردّ أمارة بيت المقدس، وأن يُثبت عبقرية عسكرية فذّة في موقعة حطين! صحيح أنّ أولاده ما كانوا في مستوى الأخطار الجسيمة، التي كانت تحيق بالمنطقة من كلّ حدب، ولكنّ شقيقه العادل والصالح نجم الدين من بعده، حملا الراية، وأقاما دولة عظيمة الشأن، بعد أن أجهزا على ما تبقّى من الأمارات الصليبية، دولة سيظلّ صيتها شائعا على مرّ الأزمان!
وإذن، فانّ الهواجس التي أبت أن تفارقه ؛ مُتمحورة في تفاصيل لا أهمية لهل ربّما ، دفعته لأن يتخفّف من قبره، وينهض من رقدته خفيفاً ؛ على أمل البحث عن أجوبة للأسئلة المزدحمة في الرأس كقفير نحل، لاسيما بعد أن نأت تلك الأيام التي كانت تترافق بتأنيب في الضمير ؛ كان يساوره نحو بشر اجتثّ أحلامهم لحساب حلمه الخاص!
وعند الصباح حطّت راحلتة رحالها عند إحدى بوّابات القدس، بيد أنّه بُوغت بالتفتيش الدقيق الذي أخضع له على يد جنود غريبي الملبس والسحنة، يعتمرون خوذاً لم يألفها، ويتنكّبون أسلحة لم تقع عينه على مثيل لها!
" ولكنّهم لايتكلمون العربية! " ـ قال الناصر لنفسه ـ " فهل جاءت العرب بجنود من خارج البلاد بقصد الحماية!؟ ولكن متى كان الغريب على استعداد لأن يبذل روحه رخيصة في سبيل بلد لا يربطه به حبل السّرة!؟ " تفكّرَ " ما الذي يحدث!؟ وكيف !؟ حماس..الجهاد الإسلامي، وفتح، وهذا الجدار الملعون الذي يقتنص من الأرض لبّها والعقل! ولكن أين كان العرب من هذا كلّه، وكيف تفرّقوا في جهات البلاد شيعاً ومللا!؟ لماذا خدعت الحكومات شعوبها، وتحايلتْ على هزيمتها في حزيران تحت مسمّيات عجيبة كالنكسة!؟ لقد استرددنا الأرض، فكيف فرّطوا بالجولان وجنوب لبنان والضفّة !؟ ولماذا تماهوا بالآخر هذا التماهي كلّه! ؟"
الأسئلة تلو الأسئلة كانت تجتاح الكيان، الذي أعلن يوما بأنّه لم ينتصر بسيوف جنوده، بل بعقول علماء الأمة ومُفكّريها!
كان الإسرائيليّون قد أطلقوا سراحه، بعد أن تحقّقوا من أنّه لاينتمي إلى أيّ جهة ! فهامّ على وجهه في الأزقة، وعلى حين غرة اجتاحته الجموع الهاربة، فيما الرصاص يئزّ من حولها، ولا سلاح إلا الحجارة، ذاهلاً عن نفسه كان، عندما أمسك الطفل بذيل ثوبه ..
ـ يللا ياعم .. هذول الصهاينة ممكن يكتلوك!
ـ لماذا! ؟
ـ معاهم فش اشي اسمه ليش، يللا ياعم.. يللا بسرعة!
وانقاد الناصر لمنطق الطفولة البريء، أمّا مُصطلحات من مثل التطبيع وعرب أوسلو أو عرب أمريكا أو الأرض مقابل السلام أو السلام " العادل "، فلم يسمع بها إلا من ذوي الصغير، وبمقدار ما أغضبه موقف العرب ؛ بمقدار ما أعياه الفهم، كان ما يدور من حوله يفوق طاقته على الاستيعاب، فاستأذنهم في الرحيل مع هبوط الظلام!
ـ ولكن التجوّل محذور ياعم!
ـ سأجد وسيلة للتخفّي!
ونظر في عيني الطفل طويلاً، كان الرجاء الحار يلوب في بؤبؤي الصغير، فمرّ بيديه على وجنتيه ؛ تمسحان دمعتين عزيزتين على قلبه، وسأله..
ـ لم تقل لي اسمك يا بن أخي! ؟
ـ عرفة .. بكولولي عرفة ياعم!
ـ 4 -
ثمّ أنّ غيمة من التسآل لفّت الرجال الثلاثة، كانت وجوههم المُتجهّمة تشي بتفكير عميق، وكانت الهواجس تحوم فوق رؤوسهم جارحة وحادة ..
ـ كيف وصل الحال إلى ما وصل إليه! ؟
ـ أين أخطأنا!؟ وماهو الخطأ، وما هو الصواب !؟ من الذي يحدّد هذا من ذاك، وما المرجعية، أو ـ حتى ـ المنطق في التحديد!؟
مُستغرقين في بحران حيرتهم كانوا، فما تنبّهوا إلى الراجل المهيب الذي راح يدنو منهم على عجل، وهو يقول؛
ـ أتسمحون لي يا أمير المؤمنين - من بعد السلام - أن أشير إلى أنّ السبب يكمن - ربّما - في أنّ العرب افتقدت العصبيّة، فتفكّكت الأمة ...
ـ ابن خلدون!
ـ ابن خلدون!؟
ـ ثمّ أنّ العرب....
ـ على رسلك يا بن خلدون ـ ورفع ابن الخطاب يده ـ ولاتنسّ بأنّ التاريخ لم يقل كلمته فيك، ذلك أنّ اللغط الذي أثير حول دورك في تسليم مفاتيح دمشق إلى الخان تيمورلنك ما يزال قائماً ! صحيح أنّك هربت منه غرباً في ما بعد، بيد أنّ الصحيح ـ أيضا ـ هو أنّك وافقت أن ترسم له مسالك المغرب وممالكه، إنّ محنتك هي محنة العالم ياصاح!
ساهماً كان الناصر صلاح الدين كما الرشيد، إلى أن همسَ كالحالم، من غير أن يتّضح في ما إذا كان يسرّ للآخرين بسرّ شخصي، أم أنّه يشي به لنفسه ..
أيّها السادة .. لقد انتهى دورنا .. إنّه زمن
عرفة ربّما ..
مع سبق الإصرار
لصلاة على ربض من الأرض :
ولأنّك كنت من مقام الاستقامة مع شيء من الإفراط ، كان هذا الكسر الحاد ، الذي طال - في المُجتبى - حياتك ذاتها ، بيد أنّ السؤال الذي ظلّ يلحّ على نحو ممرض ، أن لماذا في هذا الوقت المُحايد بالذات وقعت الواقعة ، ولماذا تصادف وقوعها على ذلك النحو !؟ ربّما لأنّ اليوم لم يكن غائماً مُلبّدًا..عاصفاً مثلاً ، ولم يكن ربيعياً رائقاً أيضاً ، مُشمساً على نحو مُتأنّق ، أو هادئاً وسناً كما هو الحال عليه في أيام الخريف ، ولا صيفياً قائظاً يجلد أديم الأرض بسياطه ، فهل تزحلقت السماء على الأرض !؟ هل حدث شرخ ما فيها ، وتساقطت أنجمها في شقوق النهار !؟ أم أنّ شيئا من هذا وذاك لم يحدث ، ربّما لأنّ الأفلاك كانت خارجة - أساساً ـ عن سياقها ، وإذن.. فهل مضى اليوم عادياً، بحيث هرعت الناس إلى تصريف أمورها ، وكأنّ شيئا لم يحدث!؟ ربّما كانت الأمور قد تتالت بالطريقة الأخيرة ، لأنّها أقرب إلى منطق الأمور! بيد أنّ ما تقدّمَ لا يعني أنّ مدينة صغيرة كحرّان لن تفتقد عينين ذكيّتين كعينيك ، كانتا أقرب إلى ذاكرة البوح منهما إلى ذاكرة الإفصاح ! فهل كانتا تنطويان على خوف مُبهم !؟ هل كان ثمّة تهديد مُبطّن أو سافر ألجأهما إلى عبّ الصمت !؟ مهما يكن فإنّ سماء المدينة كان لها أن تنشرخ لمقتل شاب في الخامسة والعشرين من عمره ، أو ـ ربّما ـ في السادسة والعشرين ! إذْ ليس ثمّة ظهورات تعيد للأموات الروح ! لذا فإنّ وجهك الشاحب سيظلّ يشي باللحظات الرهيبة المُؤسّسة للرحيل ، وسيظلّ السؤال مُسطّرًا ، أن لماذا اكتفيتَ من الحياة بما تصرّمَ ، لترحل بتلك الطريقة المُثيرة للجدل ، مُكتفياً بأعوامك الخمسة والعشرين!؟
ذاكرة المكان :
ولأنّ المكان هو المكان ، تظل موران بلدة وادعة ، تغفو على خاصرة نهر ، جفّ - هو الآخر - في سياق غامض ، لكنّ أحداً لن يدّعي بأنّه فعلها إثر نوبة حزن ، ولا حتى على سبيل الاحتجاج ، أمّا الزمان فهو الزمان أو أكثر قليلاً ، فلماذا كان الأهل خائفون من التصريح بسنة ولادتك !؟ هل تلقّوا تهديداً من نوع ما ، على شكل تصريح مثلاً أو في إهاب تلميح !؟
في هذه البلدة المُترعة بهمومها الصغيرات ، وبحسب ما جاء في الحكايات ، عاش أبو أنور في غرفة مُقببّة ، تلحق بها غرفة أخرى أصغر.. ترابيّة طبعاً ، كانت في قسم منها منزلاً ، فيما حوّل البقية إلى ورشة صغيرة لإصلاح مواقد " الكاز"، التي كان الأهالي يطبخون أطعمتهم عليها ، إلى هذا المكان تنتمي البدايات ، التي ستؤسّس لأسرة مُتحابّة ، أسرة سيكون لها صيت طيب ، كان الأب يجهد ما بوسعه ليُقدّمَ لأسرته احتياجاتها المُختلفة ، أمّا أنور فسيتخرّج من كليّة الهندسة ، قسم العمارة ، وسيُكمل شقيقه جورج دراسة الموسيقى ، حتى الأم -كما جاء على لسان الأهالي- كانت يدها مُباركة، ونفسها على الطعام طيباً ، لقد كانت امرأة قنوعة ، وأمّاَ مُحبّة طيّبة!
وتظلّ موران العنوان الأوّل، والخاتم الأوّل الذي يمهر قلبك بميسمه ، لأنّها تُحيل إلى مرابع الطفولة ، وتختصر بهاء الأمكنة في أحرفها الخمسة ، ما يدمغ المُخيّلة والفؤاد بتفاصيلها السحريّة إذن..فالنهر والإثل والشجيرات المُرصّعَة على طرفيه لن تغيب عن ذاكرة الطفولة ، إذْ أنّ هذه الأماكن هي التي كانت تشكّل مخابئ مثاليّة ، تخفيك وأترابك عن عالم الكبار الرصين ، ناهيك عن أنّها كانت ملاجئ لفخاخ القطا والزيزان ، بعيداً عن انتحار النهر الآن ، ربّما لأنّ الأمر - إذاك - كان مختلفا !
أمّا الأخويات الكنسيّة ذات الأنشطة الاجتماعية ، المُتشحة بلبوس دينيّ لأقليّة تخشى ـ أساساً ـ الذوبان في مُحيط مسيحيّ أكبر ، فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بمُحيط إسلاميّ أكبر فأكبر !؟ أمّا تلك الأخويات ، فكانت تستأثر باهتمامك الدائم ، هناك نسجت الحكايا تفاصيل أوّل قصّة حبّ ، عشتها مع فتاة في مُنتهى الرقّة والجمال تُدعى زينة ، وفي ظلّ عريشة عنب راحت تتسلق جدران المكان بوله ، تذوّقتَ طعم القبلة الأولى ، وعرفتَ أسرار التشوّف والحنين واللايُسمّى من الأحاسيس الثرّة والمُتناقضة في احتدامها وتدفقها ، لكنّ الخدمة الإجبارية في الجيش ستقف لك بالمرصاد ، لتقتطع من عمرك سنتين أو أكثر ، وقد لا تكون المُعضلة في الخدمة الإجباريّة ذاتها ، بيد أنّ المُمضّ في الموضوع هو إحساسك بالفوات ، ذلك أنّ البلد - كما سيجيء على لسانك مراراً - لم يكن قد أطلق رصاصة واحدة نحو العدو منذ ما يربو على الثلاثين عاماً !
فصل الظهورات :
ألهذا السبب أحسّ الصديق بأنّ الجهات تتداخل وترتطم !؟ هل كان للأمر علاقة بدورة الأفلاك ، ومواقع النجوم !؟ ألهذا ـ وفي أوقات بعينها من السنة ـ كان سلوك عصابيّ يركب أنور ، فيعتزل الناس ما أمكن !؟ بيد أنّ أحدًا لن يتنبّه إلى تطابق هذا السلوك مع فترات تعذيبه ، ولن يتسنّى لأحد أن يضع يده على ميله المتنامي نحو فكرة الانتحار، حتى أنّ الأمر بمجمله كان يبدو كعطب ما في الإطار العام ، أو انحراف في البوصلة ، أو خلل في النظام الأرضيّ !
ذلك أنّ أنور ، وهو يُساق إلى الجيش ؛ قادته النجوم في ساعة نحس ربّما ، أو لأنّ القمر كان في محاقه المُلغز ، إلى مطار " العين " اللاطي بالقرب من العاصمة ، وعلى نحو ما بدا الأمر مُرتبطاً بحظّه ، الذي سيكتشف لاحقاً إلى أيّ حدّ كان عاثراً ، هناك وجد نفسه موضع ترحيب ، سيتبيّن - في ما بعد - بأنّه زائف هو الآخر ، إذْ أن ّالضابط المسؤول خاطبه بلهجة أبوية :
- من حسن حظنا أنّك مُتخصّص في هندسة العمارة.. سنُسلّمك مًخططات المطار، ولابأس من أن تعلّم الأولاد أيضاً !
إلا أنّ أنور الذي كان قد تربّى بطريقة سليمة أو خاطئة ، إذْ من الذي يستطيع الجزم في مسألة كهذه ، سيجيب بوضوح طلقة :
- ولكنّني هنا لخدمة بلدي، وليس لتعليم أولاد الناس .. سيّدي!
وسيتفاجأ الضابط بالإجابة ، غير أنّ تفاجؤه لن يطول ، إذّ أنّه سيحسم الأمر بسرعة ، ولن تمرّ أيّام معدودات حتى تأتي ثلّة من البصّاصين ؛ لتقتاد أنور من قطعته ، وهناك سيجابه بالسؤال المُمرضّ أن " متى، وكيف !؟ " متى قامَ بتسريب المُخططات إلى العدو، وكيف !؟ تلك كانت الأسئلة التي ذهبت بعقله إلى حافات الخلل !
غبّ هذه اللحظة لن تكتمل أركان هذه الحكاية إلاّ بنقاط ، تومئ إلى فترة مجهولة قضاها أنور في " ضيافة " أولئك القوم، ولذلك سيكون على المخيّلة أن تحيك مُجرياتها في تلك الفترة من وحي المُخيّلة ، لكنّ الضغوط المُبهظة مُستترة بلحظة حميمة ، على سكر ربّما ، ستدفع أنور إلى أن يشي فيها لصديقه، بأنّهم لم يوفروا وسيلة تعذيب لم يُجرّبوها معه ، آنئذ تلفّت أنور حوله بحذر، وقرّب فمه من إذن صديقه هامساً:
- أنت لن تصدّق بأنّهم لاطوا بي حتى ! وها أنت بعد هذا كلّه تتساءل عن سبب تهتك علاقة الحبّ التي كانت تجمعني بزينة ، أنا أعذرك ، فأنت لم تجرّب ما حدث لي ، ولذلك فأنت لن تعي ما معنى أن يستحيل على المفعول به أن يلعب دور الفاعل ثانية !
* عن الرماد والديكة وأشياء أخرى:
ولأنّك في تحوّلاتك مررتَ بفصل الرماد ، طالك التغيّر والتشظي والانقسام كثيراً ، إذْ راحت عيناك ترمشان بصورة لا إراديّة ، فيما استوطن القلب خوف مُبهَم ووُحشة ، لا سيما عندما كانت أيّام التعذيب تضغط على الذاكرة المُدمّلة ، فتتلبّسك حالة تشبه الحلول ، ولا تعود تنتمي إلى المكان إلاّ بجسدك ، أمّا الروح والعقل والقلب فكانا أرضاً مُستباحة للتوزّع والتحوّل وخراب الدورة الدموية ، حتى أنفك راح - هو الآخر - يبدو مائلاً بصورة ما لشدّة ما عراك من نحول ، ولم تكن تعرف أنّها أحد إشارات الموت !
كان المُحققون قد أيقنوا بأنّك مُشرف على النهايات أو تكاد ، وأنّك لم ترتكب شيئا ممّا نُسب إليك ، ففضّلوا التنصّل من المسألة ، ربّما لأنّهم في لحظة حياد ، شمّوا رائحة تزكم الأنوف ، ولذلك اقتادوك إلى مرآب للنقل العام ، وطلبوا إلى بدويّ كان في العاصمة لقضاء حاجة ، أن يصطحبك معه إلى موران ! محتارًا كان الرجل، فأنت تعيش الاحتباس في النطق ، وتجهل حتى اسمك ، ولاتعرف شيئا عن مكان إقامتك ، لقد اقتنصوا مُخيلتك هناك على نحو ما ، فأضحت خربة خاوية !
وفي استراحة تبعد عن موران قرابة مائة كيلو متر توقّفت العربة ، وكان ثمّة عربة أخرى مُحمّلة بالخضار قد استراحت إلى المكان هي الأخرى ، ما دفع البدويّ إلى الاقتراب من مرافق السائق مُتسائلا:
- أليست هذه العربة التي تنقل محاصيل أهل موران !؟
فأومأ إيشايا بالإيجاب ، وأمسك البدويّ بكمّه راجياً :
- معي شاب لايعرف اسمه ، ولامكان إقامته ، لقد طلبوا إليّ أن أوصله إلى أهله ، وأنا لاأعرف كيف !
ولمّا وقعت عينا إيشايا عليك صرخ مُباغتاً :
- أنور! ! !
أمّا أنت ، فكنتَ - إذاك - تسكن إلى ملكوت آخر، إذْ كنت تحمل في يدك " صندويشة "، إلأّ أنّك لم تكن تعرف كيف تضعها في فمك ، وكانت دموعك قد اتّحدت مع مخاطك ورضابك كما في قصيدة بائسة ومُؤسية ، ولمّا اتضحت أبعاد المشهد التراجيديّ بشكل مُبهم للجميع ، قال المرافق لسائق العربة :
ـ أكمل أنت طريقك ، فأنا أعرف أهله ، سأصحبه إلى منزله ، ثمّ ألحق بك !
بيد أنّ عيون الأهل لمّا وقعت عليك ، استبدّت بها الدهشة والاستنكار على قلق ، حتى أنّهم كادوا أن ينكروك ، ثمّ وضعوك في فراشك بارتباك ، ودثروك شاكرين إيشايا الذي أكمل رحلته !
من مقام التشظي :
وأشارت الحكايا في متونها إلى أنّ تحوّلات أنور بدت بلا حدود ، فأضحى أكثر انطواءً ، أمّا لماذا أقدم على الاستقالة من وظيفته ، فتلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ! كانت البلدة تشكو شيئاً من الكساد ، ولم يكن ثمّة عمل ، فانعكس الأمر على المكتب الهندسيّ ، الذي كان قد افتتحه غبّ استقالته !
وكان أنور قد أضحى من النوع الذي يراكم المشاكل ، ويتفكّر فيها مجتمعة ، فتعظم في عينه ، فمتى يتزوج مثلا !؟ وكيف يتدبّر منزلاً !؟ كيف ينشئ أسرة !؟ وهل سيتحسن سوق العمل !؟
وفي لحظة شديدة السواد خارجة عن المُحاجَجَة المنطقية للأمور ، لحظة مُحتكمة إلى منطقها الخاص ، وسياقها غير المفهوم إلاّ لصاحبها ، سيقصد أنور رئيس بلديّة موران ، وسيطلب شيئاً من سمّ الفئران ، فيرحّب به الرجل ، على ظنّ منه بأنّ الكمية ستُستخدَم للتخلّص من القوارض ، لكنّ أنور كان قد حسم أمره ، وأحرق سفنه ، إذْ لم يعد في الإمكان إعادة الأمور إلى سابق مسارها ، وكانت جرعة السمّ الكبيرة ، التي تجرّعها كافية لترمي به في مشفى " ش" ، وهو يتأرجح بين الحياة والموت ، فكان أن اجتمع الأطباء على الحالة العاجلة، وبسرعة مجنونة ومُرتبكة أجروا له غسيلاً للمعدة ، وغزوا أبر " السيروم " في ذراعه المشعرة ، غبّ أن خلطوها بالكميات اللازمة من الأدوية ، ولم يبخلوا عليه بالحقن من كل صنف ، إلا أنّ السمّ كان قد تسرّب إلى الشرايين ، ليوقفَ دورة الحياة في الجسد الواهن ، ولم يكن أمام أنور سوى ثلاثة أيام ، قضاها بين مشفى " ش " ومشفى " ح "، ليُغادر الدنيا هذه المرّة وإلى الأبد ، رحل الشاب فجأة إذن ، وكان فراشه ما يزال يحمل دفء الجسد الإنسانيّ الحيّ ، وكان قد تجعّد وانثنى مُستجيباً لانثناءات هذا الجسد ، حتى لكأنّه كان ينتظر عودة صاحبه الذي غادره للتو!
لكنّ الحكايا تجاهلت التفاصيل المُتعلقة بكمد الأهل ، فلم تأت على فالج أصاب الأم غبّ رحيل أنور الفاجعيّ ، ولا على حركات لا إرادية وشمت المتبقي من عمر الأب ، ولا - حتى - على انكسار حاد أصاب الأخ في مقتل ، فمال إلى صمت نفور وعزلة !
عن الخواتيم في تفاصيلها الباذخة :
وأتت الحكايا في خواتيمها على تمرّد قاده نهر وئيد على الضفتين على شكل احتجاج ربّما ، لكنّ مياهه التي كانت قد غارت في فجّ عميق لم تسعفه !
وفي الإبّان ذاته جاءت الحكايا على أنّ أبواب الدور ـ التي لم تكن قد أغلقت من قبل ـ راحت ترتجّ على قاطنيها غبّ المصاب الجلل ، تاركة الأزقة تذروها الرياح ويسوسها الخوف والرعب المزروع في الأحداق !
ثمّ أردفت في متونها بأنّهم ـ ابتداءً بذات ليلة صيف ـ راحوا يسمعون همهمة صادرة عن المقابر، فهل لأنّ أنور كان يدرك بأنّه قد عبر البرزخ الفاصل بين الحياة والموت ، وأنّ أحدًا لن يطاله بعد بالعقاب ، قرّر أن يستبدل فطنة الصمت الأثيث وفتنته ، بفظاظة الكلام ، الذي لم يستطع الأهالي أن يُميّزوا فيه سوى كلمة واحدة راحت تتكرّر كثيّمة ، أن " الثااار.. الثااار.. الثار " !؟
وإذا كان هذا تلخيص ما جرى آنذاك، فلماذا زعم حارس المقبرة على نحو مُؤكّد ، وهو يُقسم بأغلظ الأيمان ، أنّه رأى رؤيا العين ظهورات الموتى للنشور، وشهد تشقق الأكفان عن أجسادهم الناحلة ذات فجر، كان أنور يسير في مُقدّمتهم كحادٍ ، مُطأطئي الرؤوس كانوا ، وكانت محاجرهم مُطفأة ، ولكن وبإصرار واثق وأكيد تحركّوا كسيل هادر ومكتوم ، لم تكن لهم ظلال مُرافقة ، وفي مفترق من المكان ارتفعت راياتهم السوداء ، ربّما لأنّ أحداً ما كان قد لصّ منهم حقّهم في الحياة ذات غفلة ، كانت العواصم المُتخمَة وجهتهم ، وكانت الأرض تئنّ تحت أقدامهم ، لقد طفح بهم الكيل ، هكذا تابع الحارس وهو يُحرّك يديه ، تقدّموا إلى الأمام ، وفوق الرؤوس كانت الثيمة ذاتها تتكرّر ، أن " الثااار.. الثااار.. الثار " !
قصص قصيرة
مأسا ة ممّي آلان
محمد باقي محمد
حقوق النشر محفوظة
لوحة الغلاف : لقمان
أحمد
الطبعة الأولى :
